البنية الناقصة للمشهد في (اكله الذئب)
عبقرية الجملة المفتوحة: محدودية التركيب مقابل اتساع التأويل.
الموقع الدلالي ونوايا المفردة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استدعاء الذئب في قصة يوسف عليه السلام يثير تساؤلًا عميقًا حول بنيته السردية ومكانته في المشهد، فعبارة “أَكَلَهُ الذِّئْبُ” (يوسف: 17) ترد بدون وصف تفصيلي، وهذا يفتح الباب أمام تحليل دقيق للدور السردي والدلالي لهذا الاستدعاء.
القرآن الكريم يمتاز بإيجازه الشديد حيث يُقدِّم المعنى بأقل عدد من الكلمات دون إضعاف التأثير. وهنا، لم يُفَصِّل في “كيف” أكل الذئب يوسف، لأن ذلك ليس جوهريًا في الحبكة.
ومن طبيعة القرأن احتفاظه بالتاريخ كحركة دلالية ديناميكية فالهدف ليس التركيز على مشهد الافتراس، بل على الخديعة والمكر، والأهمية السردية تكمن في تبرير الإخوة لجريمتهم لا في مشهدية الحدث نفسه.
إن أي إضافة وصفية (كأنيابه، دمائه، افتراسه) كانت ستؤطر القصة باتجاه الإثارة الحسية بدل التركيز على البعد النفسي والخداع.
والذئب هنا رمز وليس مشهدا فلم يكن سوى “ذريعة” لتمرير الكذب، وليس شخصية فاعلة في الحدث، وذكره وحده كافٍ لاستحضار الخطر والفقدان دون الحاجة إلى توضيح سينوغرافي (كالتقطيع والدماء).
إن الدراما النفسية تغني عن الوصف البصري ودائما نجد القصة قرآنيًا لا تهتم بالمجازر البصرية، بل بالبُعد النفسي والأخلاقي.
يلاحظ التركيز على وقع الخبر على يعقوب أكثر من الحدث نفسه، ولذلك كانت العبارة المجردة كافية لأنها تمثل عنصر الصدمة العاطفية أكثر من كونها استعراضًا سينمائيًا.
اقتصار القرآن على عبارة “أَكَلَهُ الذِّئْبُ” دون تصوير المشهد الافتراسي يعكس قصديته في الاقتصاد التاريخي لا اللغوي والتركيز على الحبكة النفسية بدل المشهدية الحسية. إنه استدعاء كافٍ لأن الهدف ليس تقديم مشهد رعب، بل كشف حيلة الإخوة وخداعهم. المغزى هنا نفسي وليس بصريًا.
ان استمرارية الإشتغال الدلالي الطازج في (اكله الذئب) رغم أن الجملة تبدو تقريرية ومباشرة، فهي تحتفظ بحيوية دلالية مستمرة عبر العصور، وذلك بسبب:
البنية الناقصة للمشهد حيث ان الجملة لا تذكر تفاصيل الحدث، مما يجعل العقل يعيد تشكيله وفق السياقات المتجددة. والرؤية المتغيرة للذئب: فـ”الذئب” تحول في القراءة الحديثة إلى رمز للمؤامرة، والافتراء، والمظلومية. كذلك من الأسباب تعدد زوايا القراءة حيث يمكن أن تقرأها من منظور الإخوة (كمبرر)، أو من منظور يعقوب (كمكيدة مكشوفة)، أو من منظور القارئ (كمجاز عن الظلم والاتهام الباطل).
إن هذه الجملة في لحظة النطق بها داخل القصة كانت مجرد ذريعة للكذب، لكن لاحقًا أصبحت مفتاحًا تأويليًا. فعند إسقاطها على مستويات تأويلية أوسع، قد تتحول إلى استعارة اجتماعية عن الظلم، أو حتى إلى “إدانة للتبريرات الزائفة” التي تُستخدم للتغطية على الجرائم
ولهذه الجملة دور محسوم في الحبكة القصصية (تبرير الإخوة)، لكنها غير محسومة دلاليًا، بل تتغير بتغير السياق، والمتلقي، والقراءة التاريخية لها. هنا تتجلى عبقرية النص المفتوح: محدودية التركيب مقابل اتساع التأويل.
(أَكَلَهُ الذِّئْبُ) نموذج للنص الذي يظل ينبض بدلالات جديدة رغم ثبات كلماته.
حيدر الأديب








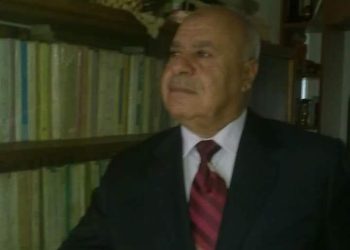
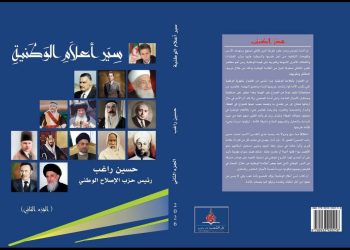

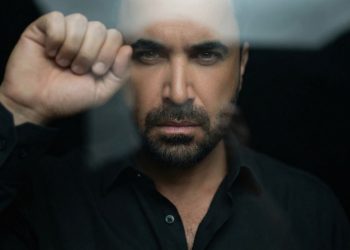









Discussion about this post